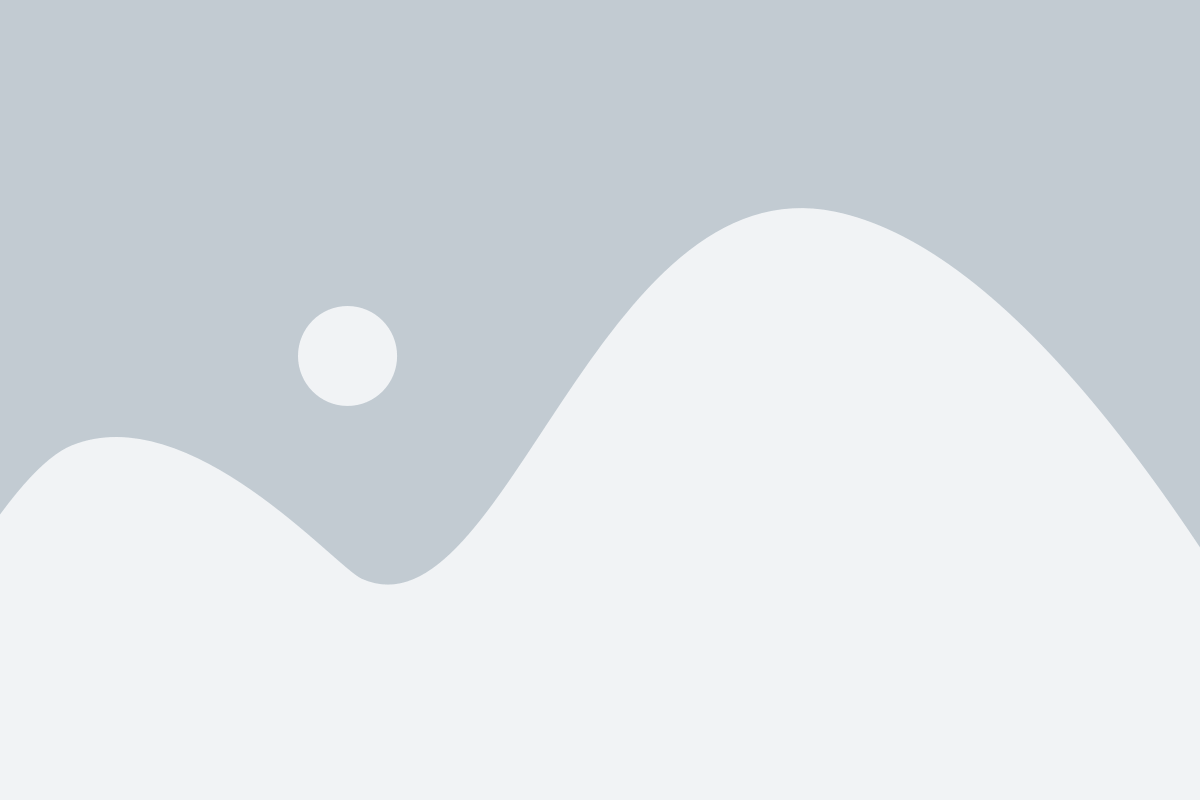أرادت أن تمضي في طريق الإحسان فمدت يداً بيضاء وأنفقت في سبيل الله… لم تترك فقيراً أو مسكيناً… وعزمت أيضاً على الإنفاق على بيوت الله، لكنها لم تكن تعرف أن إنفاقها ذاك سيخلده التاريخ بعد أن كان سبباً في إنشاء أقدم جامعة في العالم…
فَتحتْ عينَيها ذاتَ يومٍ منَ عامِ ثمانِمئةٍ للميلادِ، في أحدِ بيوتِ القيروانِ الواقعةِ اليومَ بتونس، ثمَّ حملتْها إحدى القوافلِ إلى فاسَ المغربيةِ، وَرِثتْ بعدَها كثيرًا منَ الأموالِ منْ والدِها الغنيِّ وزوجِها، ثمَّ مضتْ في طريقِ الإحسان، فاشتهرتْ بكثرةِ الإنفاقِ بسخاءٍ على المساكينِ والمحتاجين، وطلابِ العلمِ والمعرفةِ، وخاصةً في شهرِ رمضانَ، فلُقِّبتْ بالمرأةِ الصالحةِ والكريمةِ وبأمِّ البنين.
لكنَّ فاطمةَ الفهريَّةَ لمْ تكتفِ بذلكَ، أرادتْ أنْ تضعَ بصمتَها.. أنْ تبنيَ ما سيكونُ أقدمَ جامعةٍ في التاريخ.
أصرَّتْ في البَدءِ على أنْ يُبنى مسجدُ القرويينَ منْ ترابِ الأرضِ التي اشترتْها، فحفرتْ بئراً في فِناءِ المسجدِ ليرتويَ منه البناؤونَ والعاملونَ، وكانتْ تقفُ على كلِّ كبيرةٍ وصغيرةٍ حتى انتهَى البِناءُ، يقولونَ إنّها ظلَّتْ صائمةً متعبدةً وناسكةً طَوالَ مدّةِ بناءِ الجامعِ الذي استغرقَ ثمانيةَ عشرَ عاماً، وحينما لامستِ المآذنُ فضاءاتِ فاس، أصبحَ مَعلمًا، فصلَّتْ فيه حمداً للهِ وشكراً له على فضلِه ونِعمِه، ثمَّ أطلقتْ عليه اسمَ القرويينَ تَيمُّناً بمدينةِ القيروان، العاصمةِ الأفريقيةِ آنذاكَ ومسقطِ رأسِها.
ها قدْ مضتْ أيامٌ على الأولِ منْ رمضانَ عامَ مئتينِ وخمسةٍ وأربعينَ للهجرةِ، وقدْ تمَّ بناءُ هذا الجامعِ الجامعةِ، الوقفِ، على يدِ فاطمةَ الفهرية.. لِنَــرَ ماذا في الداخل؟
في محيطِ الجامعةِ شُيِّدتْ أوقافٌ لتكونَ مساكنَ للطلابِ، وقامتْ بتأمينِ مأكلِهِم إلى حينِ إتمامِ الدراسةِ، أمَّا ساحةُ الفِناءِ الكبيرِ فقدْ زُيِّنتْ بنافوراتِ الماءِ للوضوء، والجدرانُ بالزَّلِّيجِ والفُسَيفِساء، فيما الأقواسُ يحيطُها منْ كلِّ جانبٍ ويتخللُها سبعةَ عشرَ بابًا، صارَ المكانُ معماراً ثريًّا ومتناغمًا، لكنَّه في الوقتِ نفسِه أصبحَ ملتقىً دينيًّا وحضاريًّا وفكريًّا، وفضاءً مهيبًا، يحتوي على أحدِ أعظمِ الأوقافِ العلميةِ وأقدمِها على الإطلاق، احتضنَ عَبرَ التاريخِ عددًا منْ كبارِ العلماءِ مثلَ ابنِ خلدونَ وابنِ باجة، وابنِ زهرٍ وغيرِهم، وعُرِفَ أولُ نمطٍ للتدريسِ الجامعيِ حينَها، حيثُ أُنشِئَ نظامُ الدرجاتِ العلميّة، ونظامُ الكراسيِّ المتخصصةِ، وهُو ما يحاكي الأقسامَ الدراسيةَ اليوم، حيثُ كانَ لكلِّ كرسيٍّ أستاذٌ منْ خيرةِ علماءِ العربِ والأندلسِ يُعطي محاضراتٍ في حلقةٍ دائريةٍ معَ طلابِه، وشَمِلتِ الدراساتُ مختلِفَ العلومِ منَ الطبِّ إلى الفَلكِ والشريعةِ وعلمِ الاجتماعِ والفلسفةِ والحساب.
إنها قصة واحدة من قصص الأوقاف التي أقيمت هنا وهناك التي مازالَ خيرُها يتدفقُ، فمَنْ قالَ إنَّ الوقفَ يمكنُ أنْ يزيلَه الزمن؟